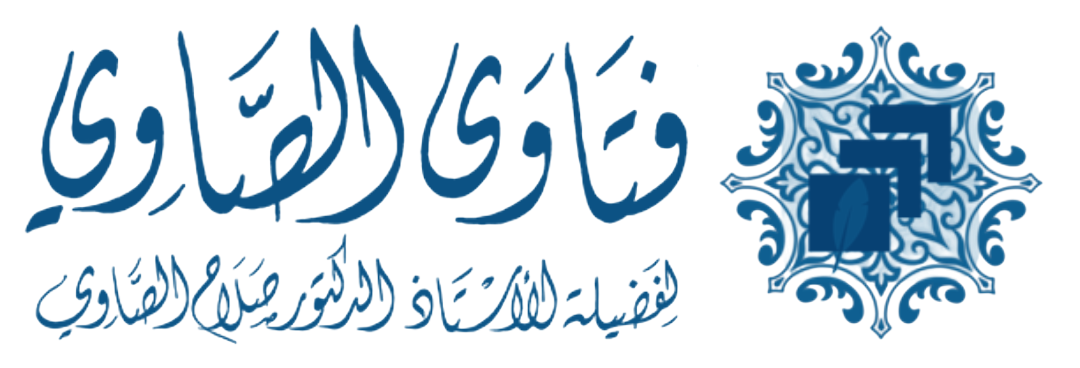نواقض الإسلام الواردة على موقع الشيخ ابن باز رحمه الله تؤدي إلى تكفير معظم المسلمين؛ لأنهم يجهلون هذا الأمر تمامًا حسبما نتلمس ذلك من الاحتكاك بالمسلمين في المساجد، فهل يُعذرون بجهلهم؟ وهل كلام الشيخ في هذه القضية نهائيٌّ؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأرجو أن تصبر نفسك على قراءة هذا الرد التفصيلي وإن أشكل عليك أمرٌ فاكتب إليَّ:
– أصل اعتبار عارض الجهل عند إجراء الأحكام:
لأن حكم الخطاب لا يثبُت في حق المكلَّف إلا إذا بلغه، على الأظهر من أقوال العلماء؛ وذلك لقوله تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ} [الأنعام: 19]. وقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل: يثبت، وقيل: لا يثبت، وقيل: يثبت المبدأ دون الناسخ، والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ…
ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيرًا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد البلوغ، فإنه ألَّا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى»(1).
– أن من الجهل ما يعذر فيه صاحبه، ومنه ما لا يعذر فيه:
وذلك بناء على أن العلم نوعان:
علم عامة: وهو ما لا يسع أحدًا غير مغلوب على عقله جهلُه؛ كوجوب المباني الخمسة، ونحوه من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذه لا عذر لأحد فيها بالجهل، ولا يخفى أن من هذا النوع ما يتعلق بالأمور العلمية الاعتقادية، ومنه ما يتعلق بالأمور العملية الفقهية، ولا يخفى كذلك نسبية هذا الأمر، وتفاوته قلةً وكثرةً، ضيقًا وسعةً بتفاوت الأزمنة والأمكنة والأحوال.
علم خاصة: وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض، ولم يرد فيه نصٌّ قاطع أو إجماعٌ صريح، وهذا الذي يُعذر فيه الجاهل بجهله، ومن أمثلته كثير من التفاصيل والفروع المتعلقة بالمباني الخمسة؛ كبعض تفاصيل التوحيد، والصلوات والزكوات والصيام والحج، ونحوه.
– نسبية العذر بالجهل:
فما يعذر به في دار الحرب غير ما يعذر به في دار الإسلام، وما يعذر به من نشأ في بادية أو كان حديث عهد بالإسلام، ليس كما يعذر به من نشأ بين المسلمين ومن كان عريقًا في الإسلام، والعذر بالجهل في الأزمنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، وطويت فيها أعلام السنة وانتشر فيها دعاة الضلالة، ليس كالعذر بالجهل في أزمنة التمكين وغلبة السنة وظهور دعاتها، وكل حالة بحسبها؛ ولهذا فإن العذر بالجهل مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص ونحوه.
ومن ناحية أخرى؛ فإن القطع والظن في المسائل إنما يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال، والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعيةً أو ظنيةً ليس صفة ملازمة لكثير من المسائل، وإنما هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين، فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة، أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره قد لا يعرف ذلك لا قطعًا ولا ظنًّا، وقد يبلغ الإنسان مبلغًا من الفهم وسرعة الإدراك يعرف به من الحق ويقطع بما لم يتصوره غيره ولم يعرفه؛ لا علمًا ولا ظنًّا، فالقطع والظن إذن في كثير من المسائل هو صفةٌ لحال الناظر المستدل المعتقد، أكثر من كونه صفةً ذاتية ملازمة للأقوال والمعتقدات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرًا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر؛ ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة؛ فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول؛ ولهذا جاء في الحديث «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَعْرِفُونَ فِيهِ صَلَاةً وَلَا زَكَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا حَجًّا؛ إِلَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ، يَقُولُ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ صَلَاةً وَلَا زَكَاةً وَلَا حَجًّا»، فقال: «وَلَا صَوْمَ يُنْجِيهُمْ مِنَ النَّارِ»(2)…)).
ثم ساق رحمه الله قصة الرجل الذي أمر أهله بإحراقه بعد موته، وتذرية رماده في يومٍ راحٍ؛ لعله يضل ربه أو يفلت من عقوبته(3)(4).
ويقول في موضع آخر: ((ولهذا لم يحكم النبي ﷺ بكفر الذي قال: «إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» مع شكه في قدرة الله وإعادته؛ ولهذا لا يكفِّر العلماء من استحلَّ شيئًا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام، أو لنشأته ببادية بعيدة؛ فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوصُ المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول بُعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، فيكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره، والله أعلم))(5).
– لا عذر بالجهل في الإقرار المجمل بالإسلام، والبراءة المجملة من كل دين يخالفه:
فكل من لم يدِن بدين الإسلام فهو كافر في أحكام الدين بيقين، سواء أكان ذلك عنادًا أم جهلًا، أما مآله في الآخرة فهو من موارد الاجتهاد، وسيأتي ذكره في المتغيرات.
يقول ابن القيم رحمه الله في معرض حديثه عن طبقة المقلدين وجُهال الكفرة وأتباعهم: ((والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله واتِّباعُه فيما جاء به، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل، فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جُهَّال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يُخرجهم عن كونهم كفارًا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله؛ إما عنادًا أو جهلًا وتقليدًا لأهل العناد))(6).
ولا يخفى أن الحديث في هذا المقام يتعلق بالجُهَّال من الكفار الأصليين؛ الذين وصفهم بأنهم جحدوا توحيد الله وكذبوا رسله، ولم يتحقق لديهم الإقرار المجمل بالإسلام، والبراءة المجملة من كل دينٍ يخالفه، ومن كان كذلك لم يعذر بجهله بالاتفاق.
ولكن موضع الخلل هو قياس المقرِّين بالإسلام في الجملة على هؤلاء الكفار الأصليين، ذلك أن عامة المسلمين وجهلاءهم يُقرِّون في الجملة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، فهم في الجملة لم يجحدوا التوحيد، ولم يكذبوا الرسل، وإن خفيت عليهم بعض التفاصيل.
ويرى فريقٌ آخر من الباحثين أن مفهوم النقولَ السابقة ليس محصورًا في الكفار الأصليين، بل هي أعم وأشمل من ذلك، فهي تشمل الكفار الأصليين وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام الذين لم يحققوا حقيقة الإسلام، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرًا معاندًا، فهو كافر جاهل.
– أن من تفاصيل التوحيد ما يعذر فيه بالجهل بيقين:
وذلك كالجهل ببعض صفات الله عز وجل، والتحاكم إلى بعض جزئيات الشرائع الوضعية، فيما ظن أن الشريعة قد أحالت فيه إلى التجربة والخبرة البشرية، باعتباره من الشئون الدنيوية؛ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُئُونِ دُنْيَاكُمْ»(7)، وكموالاة من يُجهل أحوالهم من المشركين والمرتدين ونحوه.
– ومن الأمثلة التي أوردها أهل العلم على ما يعذر فيه بالجهل مما يتعلق بالتوحيد:
أولًا: الجهل ببعض أسماء الله وصفاته:
((أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي»، عن يونس بن عبد الأعلى، سمعت الشافعي يقول: «لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردُّها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفَر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]))(8).
وقال ابن قتيبة: «قد يغلط في بعض الصفات قومٌ من المسلمين، فلا يكفرون بذلك»(9).
وقد سبق قول الغزالي عند مناقشته لمن قال: إن الجاهل بالله تعالى هو الكافر: وإن جعل المخطئ في الصفات أيضًا جاهلًا أو كافرًا لزمه تكفيرُ من نفى صفةَ البقاء وصفة القِدَم، ومن نفى الكلام وصفًا زائدًا على العلم، ومن نفى السمع والبصر زائدًا على العلم، ومن نفى جواز الرؤية، ومن أثبت الجهة، وأثبت إرادةً حادثة، لا في ذاته ولا في محل، وتكفير المخالفين فيه.
وبالجملة؛ يلزمه التكفير في كل مسألة تتعلق بصفات الله تعالى، وذلك حكم لا مستند له، وإن خصصت بعض الصفات دون بعض لم يجد لذلك فصلًا ومردًّا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرًا؛ إذا كان مُقرًّا بما جاء به الرسول ﷺ، ولم يبلغه ما يُوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه»(10).
وقد ساق- رحمه الله- عددًا من الأمثلة على ذلك، نذكر منها:
جهل أم المؤمنين عائشة بأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا:
قال رحمه الله: ((فهذه عائشة أم المؤمنين، سألت النبي ﷺ: هل يعلم الله كل ما يكتُم الناس؟ فقال لها النبي ﷺ: «نَعَمْ»، وهذا يدلُّ على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرةً، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب؛ ولهذا لهزها النبي ﷺ، وقال: «أَتَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُه؟!»(11). وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. فقد تبيَّن أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها))(12).
جهل بعض الصحابة برؤية الله يوم القيامة:
ولذلك سألوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟(13) فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، قال: ((وكثير من الناس لا يعلم ذلك؛ إما لأنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط))(14).
ثانيًا: جهل الذين يتأولون للحلوليين ويحسنون الظن بهم:
فإن فيمن يتأولون لبعضهم ويحسنون الظن بهم من أهل العلم والفضل خلقًا كثيرًا، نذكر منهم على سبيل المثال: ابن حجر الهيتمي، والسيوطي، والآلوسي، والقاسمي.. ونحوهم، ولهم في الدفاع عن ابن عربي وتعظيم شأنِه مقالات كثيرة، ولمزيد من التفصيل في ذلك نسوق مواقف هؤلاء الأئمة:
الحافظ السيوطي الذي كتب رسالة سماها «تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي»، ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فريقين: الفرقة المصيبة تعتقد ولايتَه، والأخرى بخلافها، ثم قال: «والقول الفصل عندي فيه، طريقة لا يرضاها الفريقان، وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه».
وابن عابدين صاحب «الحاشية على الدر المختار»، الذي عقد مطلبًا في حاشيته، عنون له بقوله: «مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين ابن عربي، نفعنا الله تعالى به»، وقد دافع في هذا المطلب عنه، وقال: «ومن أراد شرح كلماته التي اعترض عليها المنكرون فليرجع إلى كتاب: الرد المتين على منتقصي العارف محيي الدين، لسيدي عبد الغني النابلسي»(15).
وابن حجر الهيتمي صاحب «الزواجر» الذي صرح بأنه يعتقد جلالته ولا يعتقد عصمته(16).
والآلوسي في «روح المعاني»، فلا تكاد تخلو تفسيراته الإشارية في هذا التفسير من النقل عن ابن عربي، في «الفتوحات المكية» و«فصوص الحِكَم» وغيرها، والإشارة إليه بقوله: «قال الشيخ الأكبر قدَّس الله سره».
وحسبك هذه العبارة في تفسيره: ((ولمولانا الشيخ الأكبر -قُدِّس سرُّه- في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تقفُ الأفكار دونه حسرى، فمن أراده فليرجع إلى «الفصوص» ير العجب العجاب، والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد))(17).
أو هذه العبارة، في بيان موقفه من أقطاب الصوفية عمومًا، ومنهم القائلون بوحدة الوجود: ((ومن ذلك كتب كثير من الصوفية- قدس الله تعالى أسرارهم- فإنه قد هدي بها أربابُ القلوب الصافية، وضل بها الكثير، حتى تركوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، وعطلوا الشرائع، واستحلوا المحرمات، وزعموا- والعياذ بالله تعالى- أن ذلك هو الذي يقتضيه القول بوحدة الوجود، التي هي معتقد القوم، نفعنا الله تعالى بفتوحاتهم))(18).
وبتأمل كلام شيخ الإسلام- كما في الأصل- تجد تفريقَه بين رءوسهم الذين جعلهم أئمةَ كفرٍ وأوجب قتالهم، وبين من انتسب إليهم وذبَّ عنهم فأوجب عقوبتهم، وبين من كان جاهلًا بحقيقة أمرِهم، حيث أوجب تعريفه بما يزيل عنه اللبس في أمرهم، وكل طائفة بحسبها، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا.
ثالثًا: جهل عوام القبوريين في بعض ما يتلبسون به من عبادة غير الله، حتى تقوم عليهم الحجة التي يكفر معاندها:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكلُّ عبادة غير معمول بها فلابد أن يُنهى عنها، ثم إن علِمَ أنها منهيٌّ عنها وفعلها استحقَّ العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها، وكانت من جنس المشروع؛ فإنه يُثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك؛ فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور بها، لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهدًا؛ لأن المجتهد لابد أن يتبع دليلًا شرعيًّا، وهذه لا يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله، وهو تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع، أو لحديث كذبٍ سمعوه، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون، وأما الثواب فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم، وأما الثواب بالتقرُّب إلى الله له فلا يكون بمثل هذه الأعمال»(19).
قال رحمه الله: «ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله ﷺ لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدًا من الأموات؛ لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود للميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرم الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول ﷺ»(20).
أن من تفاصيل التوحيد ما لا يُعذر فيه بالجهل بيقين:
وذلك كنسبة الصاحبة أو الولد إلى الله، أو العداوة الدينية لجماعة المسلمين، أو سبِّ الله تعالى وسبِّ رسوله ﷺ ونحوه، مما لا يتصور وُرود عارض الجهل فيه على أحد من المسلمين؛ لكونه من المعلوم بالضرورة من الدين.
أرجو أن يكون الأمر قد تبين لك بهذ التفصيل.
أما ما نُقل عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فينبغي أن يُفهم في سياقه ومناطِه؛ لما تقدم من قاعدةِ نِسبية العذر بالجهل، وإلا فإن الشيخ رحمه الله كان من أكبر الداعمين للجهاد الأفغاني على ما يعلمه من غلوِّ كثير منهم في تصوُّفِه وفساد عقائدهم. زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) «مجموع الفتاوى» (22/41-42).
(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب «الفتن» باب «ذهاب القرآن والعلم» حديث (4049)، والحاكم في «مستدركه» (4/520) حديث (8460) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».
(3) الحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «التوحيد» باب «قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله» حديث (7506)، ومسلم في كتاب «التوبة» باب «في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» حديث (2756) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَالله لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَـمِينَ. فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ. فَغَفَرَ اللهُ لَهُ».
(4) «مجموع الفتاوى» (11/407-408).
(5) «مجموع الفتاوى» (28/501).
(6) «طريق الهجرتين» ص608.
(7) أخرجه مسلم في كتاب «الفضائل» باب «وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي» حديث (2363) من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يُلَقِّحُون- أي النخل؛ يشقون طَلْع الإناث ويؤخذ من طلْع الذكور فيوضع فيها، ليكون التمر أجود- فقال: «لَوْ لَـمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ». قال: فخرج شِيصًا (أي: تمرًا رديئًا)، فمر بهم فقال: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ».
(8) «فتح الباري» (13/407).
(9) «فتح الباري» (6/523).
(10) «مجموع الفتاوى» (7/538).
(11) أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز» باب «ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها» حديث (974) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(12) «مجموع الفتاوى» (11/412).
(13) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «تفسير القرآن» باب «قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة» حديث (4581)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «معرفة طريق الرؤية» حديث (183)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(14) «مجموع الفتاوى» (20/36).
(15) «حاشية ابن عابدين» (4/236-240).
(16) «الزواجر» ص58.
(17) «روح المعاني» (8/162).
(18) «روح المعاني» (7/7).
(19) «مجموع الفتاوى» (20/32).
(20) «تلخيص كتاب الاستغاثة» لابن كثير (2/730- 731).