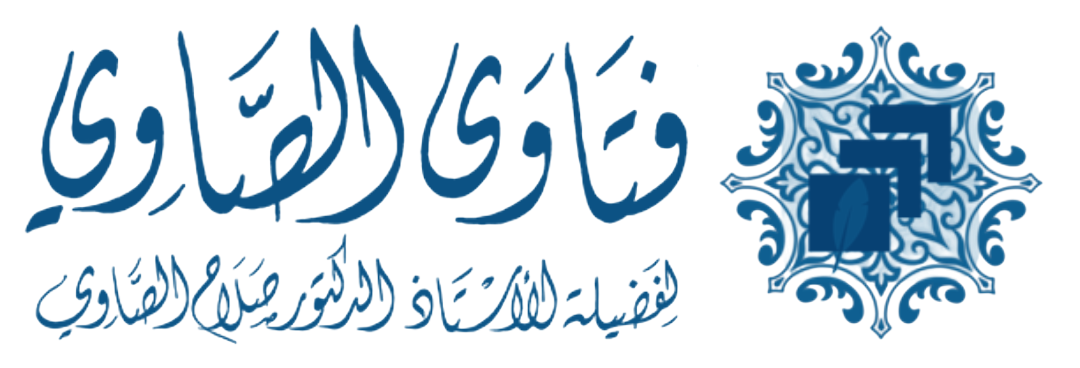إلى أين تتجه القافلة في الشرق المنكوب؟ آمال تحطَّمت، رموز تهاوت، إحباطات سيطرت على الملايين، ألا تَرون أن صمتكم جريمة؟! أين أنتم يا علماء الأرض يا ملح البلد؟ أوشكنا أن نكفر بكم جميعًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه بصائر في هذه الفتنة العمياء، أسأل الله أن يوفقني لتحريرها، وأن يجنبني فيها الزيغ والزلَّل، ما كان منها صوابًا فمن الله، وما كان منها خطأً فمني أو من الشيطان، وأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي.
أولها: أنَّ للأقوال والأعمال في الفتن ضوابط؛ قد يُؤدي تجاهُلُها إلى مزيدٍ من الفتن ومزيدٍ من الويلات والفجائع؛ فليس القول دائمًا بمنقبةٍ، وليس الصمتُ دائمًا بمثلبة، فقد نحدِّث قومًا حديثًا لا تبلغُه عقولهم فيكون لبعضهم فتنةً؛ كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في «صحيحه»: «ما أنت بمحدِّثٍ قومًا حديثًا لا تبلغُه عقولهم؛ إلا كان لبعضهم فتنة»(1). وقد نصمت فيكون في الصمت حكمةٌ ومنجاة من محنة!
لقد أنكر الحسنُ البصريُّ رحمه الله تعالى على أنس بن مالك رضي الله عنه حين حدَّث الحجاج بن يوسف بحديثِ قتل النبيِّ صلى الله عليه وسلم للعرَنيين(2)؛ لكيلا يتخذه الحجاجُ ذريعةً لتسويغ فجورِه وعربدته في الدماء.
وها هو أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين: أما أحدهما؛ فبثثته، وأما الآخر؛ فلو بثثته؛ لقطع هذا البُلعُوم. رواه البخاري في «صحيحه»(3).
وما كتمه ليس من أمر الشريعة؛ فإنه لا يجوز كتمانُها، وإنما هو ما يتعلق بالفتن من أسماء المنافقين ونحوه؛ مثل أن يقول: فلان منافق، وستقتلون عثمان، و«هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش» بنو فلان، فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه؛ فخشي أن يسمعه منه من لم تبلغه عقولُهم فيكون لبعضهم فتنةً، ويتفرق الناس بعد اجتماع.
الولايات القائمة اليومَ ليست سواء:
الولايات القائمة اليوم في بلاد المسلمين ليست سواءً؛ فمنها ما انعقد على بُعدٍ طائفيٍّ يخرج به أصحابه عن الدين كالنصيريين، والبعثيين العقديين.
ومنها ما استعلن بالعلمانية وبفصله للدولة عن الدين، ولم يكتف بإقصاء الشريعة؛ بل استعلن بمهاجمة أحكامها، ومحاربة دعاتها، وأعلن انحيازَه إلى ذلك بغير مواربة ولا حريجة.
ومنها ما كانت علاقتُه بباطل العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية أنه موروث سياسيٌّ وقانوني عن عهود سابقة، وجُلُّ همه هو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوفير الحاجيات المعيشية لعموم الناس، فهو ليس محاربًا للشريعة ولا متبنيًا لها، وليس معاديًا لأهل الدين ولا متوليًا لهم.
وقليل منها ما انعقد ابتداءً على إقامةِ الدين وتحكيم الشريعة، ثم تراجع ذلك في التطبيقِ تراجعاتٍ كبيرةً، ولكن بقيت الشريعة الدين الذين به يدينون، وإليه ينتسبون! كما قال أبو مجلز عندما سُئل عن حكام زمانه: فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدعون، فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا(4). ولكل حال من هذه الأحوال حكمه، والمعاملة التي يستحقها.
• أما ما انعقد منها على إقامة الدِّين وتحكيم الشريعة، فلا ينازع أهلُها الأمرَ مهما جاروا أو فسقوا، ما لم يبلغ بهم فسقُهم مبلغَ الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهانٌ، بل نؤدِّي لهم حقهم ونسأل الله حقَّنا، ويبقى واجبُ مناصحتهم، وإعانتهم على ما عندهم من الخير، واجتناب ما عندهم من الباطل، فلا يصدقون على كذب، ولا يعانون على ظلم، ولا يشايعون على باطل بقولٍ أو عمل، وينبغي التديُّن بطاعتهم في الطاعة ومعصيتهم في المعصية، والإقرار بما ادعوه لأنفسهم من إمرة المؤمنين، وحسابهم على الله.
• وما انعقد منها على بُعدٍ طائفي يخرج به أصحابه عن الدين، أو انعقد على العلمانية في إطارها الفلسفي، وما تعنيه من نقلِ مرجعية الأحكام من الكتاب والسنة إلى الأهواء البشرية، وتحكيم القوانين الوضعية، وإنكار مرجعية الشريعة الإسلامية، فإن ولايته منعدمةٌ؛ لما تمهَّد في محكمات العقيدة والشريعة أن الحجَّةَ القاطعة والحكم الأعلى هو الشرعُ لا غير، وأن الإرادة التي تعلو على جميع الإرادات، والسلطة التي تهيمن على جميع السلطات، والتي لا تعرف فيما تنظمه أو تقضي فيه سلطة أخرى تساويها أو تساميها، إنما هي إرادة الله عز وجل وحدَه لا شريك له. فلا دين إلا ما أوجبه الله، ولا شرع إلا ما شرعه، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، وأن من جادل في هذه البدهية فأحلَّ ما حرَّمه الله، أو حرم ما أحله، أو ردَّ شيئًا من حكمه، أو أعطى غيره حقَّ التحليل والتحريم والإيجاب والندب- فهو مارق من الدين، ومتبع لغير سبيل المؤمنين.
• فهؤلاء إن لم يمكن استبدالُهم بغير مفسدة راجحةٍ يجاهَدُون في الله عز وجل جهادَ الكلمة والدعوة والاحتساب، ويكون الخضوعُ لهم والصبرُ عليهم عند العجز عن تقويمهم سياسةً شرعية؛ دفعًا لمفاسد التشرذُم، والتغرير بالأنفس فيما لا طائل تحته، فولايتهم وإن كانت باطلةً ولكن لا ينبغي السعيُ في إبطالها إلا عند تحقُّق القدرة وتوقع الظفر وظهور المصلحة، واتفقت عليه كلمةُ أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، فهم الأقدرُ على تكييف الواقع، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والأمة تبع لهم في ذلك.
• أما من كانت علاقتُه بباطل العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية أنه موروثٌ سياسي وقانوني عن عهود سابقة، فهو كما سبق ليس محاربًا للشريعة ولا متبنيًا لها، وليس معاديًا لأهل الدين ولا متوليًا لهم، وجلُّ همه هو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوفير الحاجيات المعيشية لعموم الناس، فهؤلاء ينبغي السعي في استصلاح أحوالهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فينبَّه غافلُهم، ويعلَّم جاهلُهم، ولا يُصار إلى استعدائهم على الدين والمتدينين، بل ينبغي استفراغُ الوسع في التربية والدعوة واستفاضة البلاغ بحقائق الدين عقائد وشرائع، ومردُّ الأمر عند اليأس من استصلاح أحوالهم إلى توجيه أهل الحَلِّ والعقد في جماعة المسلمين.
ليس كل من استحَقَّ العَزْلَ وجَبَ السعيُ في عزله:
وهذا من تتمةِ القول في هذه النازلة، لا يكتمل عقدُ النصح في هذا المقام إلا بذكره، وخلاصتها أنه ليس كلُّ من استحق العزل وجب السعيُ في عزله، وليس كل ما كان باطلًا يتحتم السعيُ في إبطاله؛ لأن مردَّ ذلك إلى الموازنة بين المفاسد والمصالح، التي يقدرها أهلُ الحَلِّ والعقد والبصيرة، وليس العامة وأشباه العامة، وما يعنيه ذلك من النظر في المآل وتدبر العواقب، فإذا كان عَزله سيُفضي إلى مفاسد أعظم من الصبر عليه كان الصبرُ هو الواجبَ في هذه الحالة، وينتقل الواجب إلى إعداد العدة.
قال الشاطبي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود للشارع، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من المكلفين بالإقدام أو الإحجام، أي بالحل أو التحريم وبالصحة أو بالبطلان إلا بعد نظره إلى ما يئول إليه ذلك الفعل؛ فقد يكون مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب، أو مفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية، ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاقُ القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محبوب الغب جار على مقاصد الشرعية»(5).
رجحانُ مفسدة السعي في العزل:
• لقد ثبت من التجارب المريرة القديمة والحديثة أن مفسدةَ السعي في الخلع تربو يقينًا على مفاسد الصبر، تشهد بذلك كلُّ البلاد التي ثار أهلها، وسعوا في خلع سلطانهم، سواء أكان من المرتدين، أم كان من فسَقَةِ المسلمين، ولم يجنوا من وراء ذلك إلا رصيدًا ضخمًا من الفجائع والحسرات!
وإذا كان الفساد الذي يجلبه السعيُ في خلعهم أعظمَ من الفساد الواقع بجَوْرِهم فقد وجب الصبرُ وتركُ المنابذة دفعًا لأعظم المفسدتين، واحتمالًا لأخف الضررين، لاسيما وأن استقراء التاريخ يدلُّ على أن حركات الخروج على السلاطين في التاريخ الإسلامي قد تولَّد عنها من الشرِّ أضعافَ ما تولد عنها من الخير، ولقد ذكر أبو الحسن الأشعري خمسةً وعشرين خارجًا من آل البيت لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاحٌ.
• قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولَّد على فعله من الشرِّ أعظمُ مما تولد من الخير؛ كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق، وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضًا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة. وغاية هؤلاء إما أن يغلِبوا، وإما أن يُغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة»(6).
الصبر لا يعني المشايعة على الباطل:
وهذه كذلك من تتمَّة القول في هذه المسألة، فالصبر على ظلمة الولاة وفسَقتِهم لا يعني مُشايعتهم على باطلهم، ولا يعني تصديقَهم على كذبهم، أو إعانتهم على ظلمهم، فإن من صدَّقهم على كذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يرد عليه حوضَه يوم القيامة(7)، فالحق وسط بين الطرفين، بين من شايعهم على باطلهم، وسوغ لهم بطشهم، أو سعى في منابذتهم متجاهلًا دروس التاريخ ودروس الحاضر.
قال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود: 113].
وقد جاء النَّهيُ عن الرُّكون إلى الذين ظلموا في خواتيم سورة هود بعدَ استعراض كافَّة مشاهد الظلم والطغيان في السورة؛ باختلاف تركيبة السلطة وهيكلية الاستبداد المتعلقة بكل قوم.
ومعاني الفعل «تركنوا» التي ذهب إليها المفسرون لا تخرُج عن أفعال قلبيَّة وأفعال جارحة، أمَّا القلبيَّة منها فكانت: بالميل والمحبة والرضا، وأما الجارحة فكانت: بالسكون، والاشتراك بتزيين الظُّلم، والمداهنة للظالمين من زيارة ومصاحبة ومجالسة، والاعتماد عليهم.
وإذا كان حالُ الميل في الجملة إلى من وُجد منه ظلم ما في الإفضاء إلى مساس النَّاس النَّار- فما ظنُّك بمن يميل إلى الراسخين في الظلم كل الميل؟!
وعن جابرٍ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لكعب بن عجرة: «أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ». قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي»(8).
روى الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر- ولم يجرب عليه كذبة قط- ذكر عنه حكاية: أنه لما جاءت بيعةُ يزيد بن معاوية إلى المدينة خطب مروان ودعَا إلى بيعة يزيد، وقال فيها: ((إن الله أرى أميرَ المؤمنين في يزيد رأيًا حسنًا، وإن يستخلفه فقد استُخلف أبو بكر وعمر)). وفي رواية: ((سنة أبي بكر وعمر)). قال عبد الرحمن لمروان: جعلتموها والله هرقلية وكسروية- وفي رواية: فرد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ((بل سنة هرقل وقيصر)). وقال: ((جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم)). وفي رواية: ((ليس بسنة أبي بكر، وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة، وعدل إلى رجل من بني عدي؛ أن رأى أنه لذلك أهل، ولكنها هرقلية)). فقال له مروان: اسكت! فإنك أنت الذي أنزل الله فيك: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ} [الأحقاف: 17]. فقالت عائشة: ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن، إلا أنه أنزل عذري(9).
تمحُّض أهل العلم للنصيحة وعدم التورط في فتنة المنابذة:
ومن تتمة القول كذلك أن يتمحض أهل العلم في هذه الفتنة للنصيحة والبلاغ عن الله ورسوله، وعدم الدخول فيما دخل فيه المتعجلون، ليكونوا رجالَ ملة وليسوا رجالَ دولة، فتتعلق بهم النفوس والقلوب، ولا يجد الطغاة ما يصيبونهم من خلاله في مقتل.
وقد روي أن شيخ الإسلام ابن تيمية- وقد كان أولَ الواصلين إلى دمشق يبشر الناس بنصر المسلمين في معركة شقحب، تلك التي انتهت بنصر أهل الإسلام، ومنع التتار من دخول الشام والعراق ومصر والحجاز، وهي المعركة الوحيدة التي شارك فيها الشيخ ابن تيمية، وكان له الفضل في تشجيع الناس، والشد على عزيمة الحكام، وجمع الأموال من تجار دمشق- فعندما أحس بخوف السلطان من أن يستغل ابن تيمية حب الناس له فيثور عليه، قال: «أنا رجل ملة لا رجل دولة».
لا يُعان الظلمة إلا على من هُم أشد منهم ظلمًا:
ومن تتمة القول كذلك أن من استحق العزلَ لرِدَّته أو لشيوع ظلمه وفسقه لا يُعان على من خرج عليه، إلا إذا كان هذا الخارج أشدَّ منه ظلمًا وفسوقًا عن أمر الله، وأكثر منهم بغيًا وسفكًا للدماء، فإن الله ينتقم من الظالم بظالمٍ ثم ينتقم من كليهما، فقد تمهد أنه يقاتل مع الظالم من هو أشدُّ منه ظلمًا، ومع المبتدع من هو أشد منه ابتداعًا.
وقد روى ابن القاسم، عن مالك قوله: إذا خرج على الإمام العدل خارجٌ وجب الدفعُ عنه، مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غيرُه فدعه، ينتقم الله من ظالمٍ بمثله ثم ينتقم من كليهما(10).
كما أنه لا يجوز له قتالهم لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجَوْره، وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه.
وقال ابن بطال: «ولذلك لا يجوز القتالُ معهم لمن خرج عليهم عن ظلمٍ ظهَر منهم»(11).
وقد روى أهلُ السِّيَر أن ابنة هولاكو حين دخلت بغداد مرت بعالم جليل في حلقة علم بين طلابه، فقالت: ائتوني بهذا العالم مربوط اليدين والرجلين، فلما جاءوا به على هذه الصورة المهينة فقالت له: إن الله يحبنا ولا يحبكم، فقد نصرنا عليكم ولم ينصركم علينا، فردَّ عليها فقال: يا أمة الله أرأيت راعي الغنم؟ قالت بلى. قال: أرأيت أن له كلابًا؟ قالت: بلى. قال: فما شأن الكلاب؟ قالت: ترد ما شرَد من الغنم. قال: فذلك مثلنا ومثلكم، فالراعي هو الله، ونحن الغنم، وأنتم الكلاب، فمتى ما خرجنا عن سلطان الله سلطكم الله علينا ليردنا إلى سلطانه(12).
فتنة ولاية المتغَلِّب:
راية رفعها كثيرون، وامتُحن بسببها كثيرون، والله أعلم بما يُسرِّون وما يعلنون. نعم لقد تحدث أهلُ العلم عن ولاية المتغلِّب، وأن من غلب على المسلمين بالسيف واستتب له الأمر، وساسهم بكتاب الله وجبت طاعتُه، دفعًا للفتن التي يجلبها الخروج عليه. قال الإمام أحمد: «ومن غلبَ عليهم- يعني: الولاة- بالسيف حتى صار خليفةً، وَسُمِّي أميرَ المؤمنين، فلا يحل لأحدٍ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا برًّا كان أو فاجرًا»(13).
واحتجَّ الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: «وأصلي وراء من غَلَبَ»(14).
وفي صحيح البخاري، عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب: ((إني أُقِرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله؛ عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعتُ، وإنَّ بنيَّ قد أقرُّوا بمثل ذلك))(15).
وكان في الأرض قبل ذلك اثنان، كل منهما يُدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير، فامتنع ابنُ عمر في تلك المدة عن أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعَه.
ولم تزل الأمة تحت ولاية متغلِّبين منذ عقود متطاولة، ولكن من هو هذا المتغلب الذي تحدث عنه أهلُ العلم؟ والذي أوجبوا التديُّن بطاعته، والإقرار بإمرته متى استتبت له الأمور؟
هل هو المتغلب داخل إطار إسلامي يسوس الناس بكتاب الله في الجملة، مهما كان في خاصة نفسه من جَوْرٍ وظلم وفسوق عن أمر الله؟ أم هو المتغلب في إطار علماني لا يقرُّ بمرجعية الشريعة، ويردُّ الناس في الجملة إلى كتاب غير القرآن، وإلى متبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لقد تحدث أهلُ العلم عن صفات هذا المتغلِّب الذي تجبُ طاعتُه، والإقرار له بالولاية وبإمرة المؤمنين، ولنترك الكلمة للماوردي في أحكامه السلطانية يحدثنا عن ذلك فيقول رحمه الله:
((والذي يتحفَّظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء، فيشترك في التزامها الخليفةُ الولي والأميرُ المستولي، ووجوبها في جهة المتولي أغلظ:
أحدها: حفظُ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة؛ ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظًا وما تفرَّع عنها من الحقوق محروسًا.
والثاني: ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكمُ العناد فيه، وينتفي بها إثم المباينة له.
والثالث: اجتماع الكلمة على الأُلفة والتناصر ليكون للمسلمين يدٌ على من سواهم.
والرابع: أن تكون عقودُ الولايات الدينية جائزةً والأحكامُ والأقضية فيها نافذةً لا تبطل بفساد عقودها، ولا تسقط بخلل عهودها.
والخامس: أن يكون استيفاءُ الأموال الشرعية بحقٍّ تبرأُ به ذمة مؤديها ويستبيحه آخذُها.
والسادس: أن تكون الحدودُ مستوفاةً بحقٍّ وقائمةً على مُستحَقٍّ؛ فإن جنب المؤمن حَمِيٌّ إلا من حقوق الله وحدوده.
والسابع: أن يكون الأمير في حفظ الدين وَرِعًا عن محارم الله، يأمر بحقه إن أُطيع ويدعو إلى طاعته إن عُصي.
فهذه سبع قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام الأمة فلأجلها وجب تقليد المستولي))(16).
فهذه هي الصورة التي تحدَّث عنها فقهاؤنا وأئمتنا، ووجهُ المصلحة فيها ظاهرٌ جليٌّ.
ولكن هل يمكن إطلاقُ القول بأن كل من قهَر الأمةَ بسيفِه، واستباحَ بيضتها ببغيه، أن التديُّنَ بطاعته والإقرارَ بإمرته للمؤمنين فريضةٌ دينية، وإن كان هو يتبرأ من مثل هذه الإمرة، ويكفر بهذه الراية، ويستبيح الحرمات، ويحمل الأمة على التحاكُم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله؟!
إن من آكد شروط الإمامة الحكمُ بما أنزل الله؛ لِـمَا روى مسلم عن أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ الله تَعَالَى، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»(17). وفي رواية: «مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ الله»(18).
فجعل القيادة بكتاب الله سببًا للسمع والطاعة، وعلى هذا تُحمل الأحاديث المطلقة الواردة في طاعة الأئمة، كما في قوله: «وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»(19)، ونحو ذلك.
وقال علي بن أبي طالب: حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، ويؤدي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك فحقٌّ على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا(20).
وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» في شرحه للحديث السابق: ((وفيه ما يلزم من طاعة الأئمة إذا كانوا متمسكين بالإسلام، والدعوة لكتاب الله كيف ما كانوا هم في أنفسهم وأنسابهم وأخلاقهم))(21). اهـ
وقال أيضًا في: ((والإشارة أيضًا بقوله «يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ الله»: أي بالإسلام وحكم كتاب الله وإن جار))(22). اهـ.
وقال النووي في «شرح مسلم»: ((فأمر بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى، قال العلماء: معناه ما داموا متمسكين بالإسلام، والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم))(23). اهـ.
والخلاصة أنه لا يحل أن ينسب إلى الإسلام القول بأنه يُوطِّئ ظهور الأمة كلها لكل من اجتاحها، وقهرها بسيفه، مهما كان معتقده ومسلكه، ويحملها على أن تتدين بوجوب طاعته ظاهرًا وباطنًا، والإقرار له بإمرة المؤمنين، مهما ظاهر عليها خصومها، أو كان يردها في الجملة إلى كتاب غير القرآن، وإلى متبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففرق بين صبر يكون سياسةً مداراة لمبطل، واتقاءً لبطش متكبرٍ جبار، وبين تدين بالطاعة، وإقرار بإمرة المؤمنين ظاهرًا وباطنًا. فهذه الأخيرة لا تكون إلا لمن كان يقيم كتاب الله في الجملة مهما كان فسوقُه في نفسه.
نحن نتفهَّم حالة الاستضعاف التي تمر بها الأمة، وقد تعجز عن دفع المحاربين للشريعة، والمنتحلين للعلمانية، وقد تستكينُ لهم وتُضطرُّ إلى مداراتهم، ومصانعتهم، ولكن يبقى أنها تعقد قلبها على انعدام شرعيتهم، وعلى وجوب مدافعتهم عند القدرة على ذلك، وقد يمتدُّ هذا الضعف لعدة قرون، وقد تنشأ في ظلِّه أجيال وأجيال، ولكنها تبقى على هذا الأصل، يتوارثه الأحفادُ عن الأولاد، وتتقلدُه دينًا ومعتقدًا، إلى أن يأتي اللهُ بالفتح أو أمرٍ من عنده.
وكما لا يقبل أن يدفع عاقلٌ بأمته إلى المحارق والمهالك، أو أن يُدخلها في مواجهة تُجتَثُّ فيها شأفتُها، وتُستباح فيها بيضتها، وتزهق فيه أرواحها في غير طائل، فإنه لا يقبل كذلك وبنفس القدر أن يحملها أحدٌ على الاعتقاد بشرعية العلمانية والعلمانين، وتسويغ ما يدعُون إليه من الفصل بين الدين والدولة في بلاد المسلمين، وأن للقائمين على ذلك ولاية شرعية، نبذلها لهم طائعين مختارين، ونتدين بوجوب إلقاء السلم إليهم طوعًا وكرهًا في العسر واليسر والمنشط والمكره؛ تمامًا كما نفعل مع أئمة المسلمين وإن كانوا ظالمين، إن الحق وسط بين الغلاة والجفاة. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________________________________________
(1) أخرجه مسلم في «المقدمة» معلقًا عقب باب «وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى».
(2) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «أبوال الإبل» حديث (233)، ومسلم في كتاب «القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب «حكم المحاربين والمرتدين» حديث (1671)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن ناسًا من عُرَيْنَة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِـهَا». ففعلوا، فصحُّوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدُّوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثَرِهِم، فأُتِيَ بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَلَ أعيُنَهُم وتركهم في الحَرَّةِ حتى ماتوا.
(3) أخرجه البخاري في كتاب «العلم» باب «حفظ العلم» حديث (120).
(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (6/ 252).
(5) «الموافقات» (4/ 195).
(6) «منهاج السنة النبوية» (4/ 527 – 528).
(7) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (5/ 111) حديث (21111)، والحاكم في «مستدركه» (1/ 151) حديث (262)، وابن حبان في «صحيحه» (1/ 518) حديث (284)، والطبراني في «الكبير» (4/ 59) حديث (3627)، وابن أبي عاصم في «السنة» (2/ 352) حديث (757)، عن عبد الله بن خباب بن الأرتِّ قال: حدثني أبي خباب بن الأرت قال: إنا لقعود على باب رسول الله ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر إذ خَرج علينا فقال: «اسْمَعُوا». فقلنا: سمعنا! ثم قال: «اسْمَعُوا». فقلنا: سمعنا! فقال: «إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ، فَإِنَّ مَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، فَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْـحَوْضَ». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 248) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن خباب وهو ثقة»، وصححه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (757).
(8) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/ 321) حديث (14481)، وذكره المنذري في «الترهيب والترغيب» (3/ 134) وقال: «رواه أحمد واللفظ له والبزار ورواتهما محتج بهم في الصحيح».
(9) ابن كثير في «البداية والنهاية» (8/89).
(10) «أحكام القرآن لابن العربي» (4/128-131).
(11) «عمدة القاري» (14/221).
(12) «مطالب أولي النهى» (6/263-264).
(13) الطبقات الكبرى» (4/149).
(14) أخرجه البخاري في كتاب «الأحكام» باب «كيف يبايع الإمام الناس» حديث (7205).
(15) «الأحكام السلطانية» (1/39-41).
(16) أخرجه مسلم في كتاب «الحج» باب «استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا» حديث (1298).
(17) أخرجه الترمذي في كتاب «الجهاد» باب «ما جاء في طاعة الإمام» حديث (1706)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(18) أخرجه مسلم في كتاب «الإمارة» باب «الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» حديث (1847)، من حديث حذيفة رضي الله عنه.
(19) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/418) حديث (32532).
(20) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» (4/195).
(21) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» (6/137).
(22) «شرح النووي على صحيح مسلم» (9/47).
(23) «شرح النووي على صحيح مسلم» (9/47).